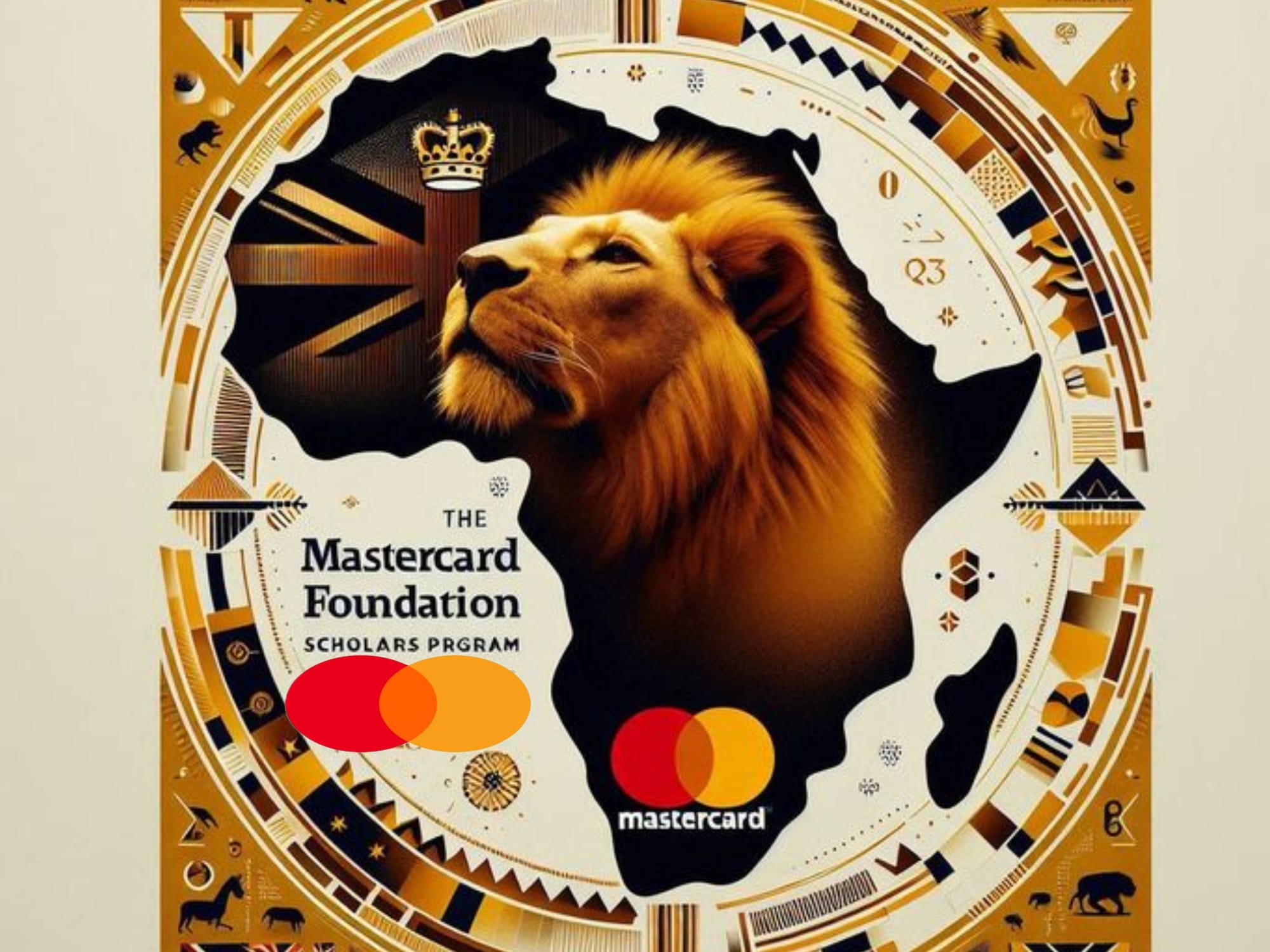في نهايات العام الثالث لبرنامج التدريب في طب الأسرة في جامعة لايدن بهولندا ، خُصص آخر كورس لموضوع التمارض. وكان هذا الترتيب مقصوداً، حيث خُصصت السنة الأولى للأمراض الشائعة في المراكز الصحية، وخصصت السنة الثانية للمستشفيات، خاصة طب الطوارئ والنساء والتوليد والطب النفسي ، وكأن البرنامج أراد أن يترك لأطباء الأسرة في ختام تدريبهم واحدة من أعقد القضايا في الممارسة اليومية وهي ظاهرة التمارض ، أو ما يُعرف في اللغة الإنجليزية بـالسوماتايزيشن ، و يعتبر هذا التدريب من الكورسات المهمة، لأن التمارض من القضايا المعقدة في الممارسة الطبية اليومية ، إذ يتجسّد القلق النفسي أو الضغوط الإجتماعية عند المريض في شكل شكاوى جسدية متكررة ، لا يدعمها غالباً مرض عضوي واضح. هذه الشكاوى قد تتراوح بين ألآم متفرقة ، أو اضطرابات هضمية ، أو صداع مزمن ، أو ضيق في التنفس ، وكلها تستهلك وقت الطبيب والمريض في دوامة فحوصات غالباً ما تنتهي بلا نتائج حاسمة. تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المصابين بالتمارض تتراوح بين 0.1% إلى 0.7% في مختلف المجتمعات، بينما تصل نسبة الأعراض التي لا تفسير لها طبياً ما بين 10% و20% من مراجعات المرضى مع الأطباء. وتكمن أهمية الظاهرة في أثرها الكبير على ميزانية الصحة العامة و أثرها السلبي الكبير عليها ؛ ففي بريطانيا، قُدرت الخسائر المباشرة لعلاج هذه الحالات في عام 2008–2009 بـحوالي 3.1 مليار جنيه إسترليني (4.2 مليار دولار) ، وإذا أُضيفت الخسائر غير المباشرة، كالغياب عن العمل وتراجع الإنتاجية في المؤسسات و الشركات ، إرتفع الرقم إلى نحو 17.1 مليار جنيه إسترليني في تلك السنة ما يعادل (23.1 مليار دولار أمريكي). في كورس التمارض بجامعة لايدن، برز اسم الأستاذ لووك دي راوتر ، نائب رئيس برنامج تدريب طب الأسرة وخريج علم النفس من جامعة أمستردام ، الذي لعب دوراً محورياً في تدريب الأطباء على مهارات التواصل مع المرضى. التواصل لم يكن محصوراً في الفحوصات، بل في بناء علاقة قائمة على الإصغاء والتعاطف وفهم السياق الاجتماعي للمريض. لأن التمارض لا يُعالج بالفحوصات المختبرية فقط ، بل بفهم ما وراء الشكوى الجسدية وتحليل الإشارات غير اللغوية، المعروفة بلغة الجسد، والتي تشكل 80% من التواصل بين الناس. من الممارسات المعروفة في طب الأسرة في الدول الغربية أن الطبيب ينادي المريض بنفسه من غرفة الانتظار ، وفي هذه الثواني يلاحظ الكثير: من طريقة الجلوس مع المرافق فإذا كانت حميمية فذلك يفيد بجودة العلاقة الأسرية ، و من طريقة مشي المريض الى العيادة يستنتج الطبيب حالة الجهاز الحركي و المفاصل ، وكل تلك الملاحظات تعطي مؤشرات مهمة على الحالة العضوية والنفسية للمريض. بعد إنتهاء التدريب، عملتُ في إحدى عيادات طب الأسرة في حي رايسفايك بمدينة لاهاي ، وهناك قابلت مريضة تُجسد الظاهرة بوضوح. السيدة "سنغ" (إسم مستعار)، كانت آنذاك في بداية عقدها الخامس ، وهي مواطنة هولندية سورينامية (مستعمرة هولندية في أمريكا الجنوبية) و تنحدر من أصول هندية ، السيدة سنغ متحدثة لبقة، قوية الحجة، تعرف تماماً ما تريده من تحويلات أو فحوصات، وتُجيد استخدام المصطلحات الطبية بسبب ترددها على الكثير من الأقسام . وخلال عام من عملي هناك، لم أتمكن من مساعدتها بالشكل الذي كنت أرجوه ، إذ كانت تجسد "المريض المحترف". قبيل دعوتها من صالة الإنتظار ، قمت بمراجعة ملفها الإلكتروني ، فوجدت أنها زارت العيادة 285 مرة خلال خمس سنوات، أي بمعدل زيارة كل ستة أيام ، غير مراجعاتها للمستشفيات والفحوصات المتعددة ، بل أنها أقنعت طبيب القلب بإجراء قسطرة استكشافية أثبتت سلامة الشرايين ، رغم أن تكلفتها في ذلك الوقت كانت حوالي 2500 دولار. لاحقاً، عند انتقالي إلى قطر، وعبر عملي في مركز أبوبكر الصديق الصحي، واجهت مرضى يحملون نفس التشخيص ما يعزز من الاحصائيات العالمية في هذا المنحى . غير أن النظام الصحي المجاني في قطر ، كما هو الحال في بريطانيا ، يجعل من الصعب إقناع بعض المرضى بعدم جدوى الفحوصات ، خاصة حينما يكون مبدأ "المجانية" متجذراً في الذهنية الجماعية. لكن بالطبع، لا توجد مجانية مطلقة ؛ إذ تتحمل الدولة التكاليف المتزايدة لتقنيات الطب الحديثة: و لمزيد من الدقة فالتمارض ليس خداعاً مقصودا من قبل المريض ، بل يحدث بسبب عجز المريض عن تفسير إشارات جسدية بسيطة، كالانتفاخ في البطن أو الطنين الذي يصيب الأذن بين الفينة و الأخرى ، التي غالباً ما تزول تلقائياً بفضل الجهاز المناعي للإنسان. مشكلة التمارض كما أسلفت أعلاه تكمن في أثرها الكبير على النظام الصحي ، خصوصاً في الدول الفقيرة. لكن إذا تزايد عدد المرضى بهذا التشخيص في أي مجتمع خاصة في المجتمعات الغنية نسبيا فإن ذلك يؤدي إلى إهدار موارد كبيرة و يتجلى ذلك في عدة أوجه منها الضغط على الكوادر الطبية حيث يواجه الأطباء حالات يصعب تفسيرها ، ما يزيد من الإرهاق المهني، ويقلل من الرضى الوظيفي ، خاصة حين لا يلمس الطبيب تحسناً واضحاً رغم الجُهد المبذول. كما تتراجع ثقة المرضى في الكوادر الطبية، ما يدفع بعضهم نحو السياحة العلاجية التي تستغل الظاهرة وتسوق لها بوسائل إعلام غير منضبطة. أيضا يؤدي تزايد اعداد المرضى المصابين بهذا المرض إلى تشويه أولويات النظام الصحي حين تهيمن هذه الشكاوى على الوقت، يختل التوازن بين الوقاية، علاج الأمراض المزمنة، والاستجابة للطوارئ. البعد النفسي والإجتماعي لا ينبغي النظر للتمارض كضُعف شخصية، بل هو في كثير من الأحيان استغاثة صامتة يطلقها الجسد. وهنا تُبرز أهمية دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية، وبناء علاقة ثقة تساعد المريض على التعبير بطرق أكثر نفعاً. في تقديري أن طبيب الأسرة هو حجر الزاوية في علاج هذه الظاهرة ، لما توفره طبيعة عمله من تواصل متكرر مع المريض ، عبر مقابلات الأمراض المزمنة ، الالتهابات الموسمية ، آلام الجهاز الحركي ، التطعيمات الموسمية، وحتى استشارات السفر ، و ممارسة الرياضة. هذا التراكم في اللقاءات يُنتج علاقة تُمكن الطبيب من ربط الأعراض ببعضها ، وترشيد الفحوصات بناء على معرفة متواصلة ، وهي ميزة لا يتمتع بها أطباء المستشفيات. الذين لا تتيح لهم ظروف عملهم إلا برؤية بُعد واحد من حالة المريض وهي تتم مرة واحدة الى مرتين سنويا. الخُلاصة،،، مواجهة التمارض تتطلب وعياً متزايداً لدى مقدمي الخدمة الصحية و تدريب متقدم لتشخيص المرض و التعامل معه ، واستراتيجيات واضحة في فرز الحالات ، وتكاملاً بين الطب الجسدي والنفسي. كما أن التثقيف المجتمعي ونشر ثقافة الصحة النفسية يساهمان في تقليل الظاهرة وتخفيف الضغط عن موارد النظام الصحي سواء لدى في البلدان الغنية أو الفقيرة.
ظاهرة التمارض وأثرها على إستدامة النُظم الصحية
بقلم: د. أمجد إبراهيم سليمان